مرافئ الحب
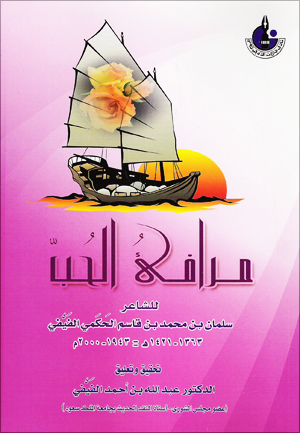

(7.92 Mb)
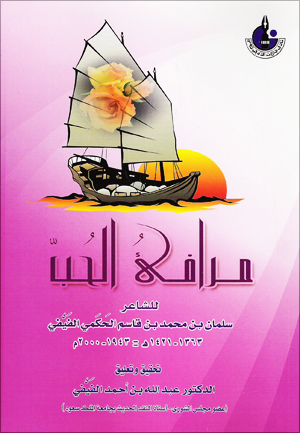

(7.92 Mb)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرافئُ الحُبّ
للشاعر
سلمان بن محمد بن قاسم الحَكَمـي الفـَيْفـي
(1363 - 1421هـ= 1943 - 2000م)
تحقيق وتعليق:
الدكتور عبدالله بن أحمد الفَيْفي
( عضو مجلس الشورى- أستاذ النقد الحديث بجامعة الملك سعود )
حقوق الطبع محفوظة
( الطبعة الأولى، نادي جازان الأدبي: 1428هـ= 2007م )
عدد الصفحات: 290
المقدمة:
- 1 -
وُلد الشاعر سلمان بن محمّد بن قاسم الحَكَمي الفَيْفي في فَيْفاء، بُقعة الخَشْعَة، جبل آل بِلْحَكَم (أبي الحَكَم): سنة 1363هـ= 1943م. وتلقّى تعليمه الأوّليّ في مدرسة الخَشْعَة ، في فَيْفاء ، إذ التحق بها سنة 1373هـ. ثم انتقل للدراسة بمعهد ضَمَد العلمي. ثم عاد إلى فَيْفاء، فعُيّن مدرِّساً في مدرسة الخَشْعَة، وكانت تُسمى (معهد الخَشْعَة) .
وبعد إلغاء مدارس القرعاوي ، التي كانت تُعدّ مدرسةُ الخَشْعَة إحداها، انتقل الشاعر للالتحاق بمعهد سامطة العلمي. فدَرَسَ في معهد سامطة في قسمه التمهيدي، فالمتوسط، فالثانوي، وحصل على شهادة المعهد، (القسم العامّ)، سنة 1386هـ.
ثم التحق بكلية اللغة العربية في الرياض، وحصل على شهادة الليسانس سنة 89/ 1390هـ. ليلتحق بالتدريس في معهد الرياض العلمي سنة 1391هـ. وبعد عمله هناك سنة دراسية، انتقل للعمل مدرِّسًا في المعهد العلمي في عَرْعَر . واستمر في التعليم في معهد عَرْعَر العلمي، ليشغل فيه بعد سنوات وظيفة وكيلٍ للمعهد، ثم مديرٍ للمعهد، قبل أن يَطلب التقاعد المبكّر، نظراً لظروفه الصحّيّة.
عانى الشاعرُ الأمراضَ منذ صِباه. وكان آخرها أن اكتشف الأطباء، في بداية سنة 1421هـ، إصابته بتورّم خبيث في الكبد، تبيّن أنه حالة متأخّرة لسرطان، أُعلن عن استحالة علاجها. فكابد مرضه ومضاعفاته بصبرٍ عجيب، حتى توفّاه الله في بيتي في الرياض، في شهر رمضان من السنة نفسها، 1421هـ= 2000م.
عرفتُ الشاعر شغوفاً باللغة العربية وآدابها. فلقد تتلمذتُ على يديه، ثم خَبِرْتُهُ عن كثب، في مُقامه وسفره، وذلك بحُكم القرابة؛ فبيني وبينه ما كان بين طَرَفة والمُتلمِّس، أو بين الأعشى والمسيّب بن علَس.. ثم بحُكم رابطة التخصّص والاهتمام المشترك. فكان المثقّف، المطّلع، القارئ من الدرجة الأولى، الحافظ، حاضر الذاكرة، سريع البديهة. حتى إن بعض زملائه كانوا يلقّبونه بـ"الموسوعة"؛ نظراً لتردّدهم عليه- كلما حزبهم سؤال لغوي أو أدبي- أعيتهم إجابته. وكان إلى ذلك شديد التواضع والزهد في الأضواء. ومن آثار ذلك عدم اهتمامه بنشر شعره في حياته، مع كثرة ما كان يلحّ عليه في ذلك أصدقاؤه ومحبوه.
كما كان كريماً، جميل المعشر، خفيف الظلّ، يُشيع الدُّعابة والفرح أينما حلّ أو ارتحل، وإنْ في أحلك الظروف. وفي أجواء مرضه الأخير- الذي يكفي ذكره ليبعث الفزع والأسى والحزن- كان سلمان صورة أخرى من الناس، ونسيجًا فريدًا من النفوس. إذْ أبى إلا أن يكون شجاعاً، صابراً، محتسبًا، كبير النفس إلى آخر لحظة.. يذكّرك بقول أبي الطيب المتنبي:
وإذا كانت النفوسُ كباراً
تعبتْ في مُرادها الأجسامُ
وكان حاد الذكاء، لمّاحاً، لَبِقًا، محبوباً من كل من عَرَفَه. كما كان ساخراً بالحياة وتقلّباتها.. واستمرّ على ذلك حتى آخر أيامه. ولعل في نصوصه الشعرية ما يدلّ على تلك السجايا فيه.
وكان- رحمه الله!- ذا همة عالية، جعلته ملجأ القاصي والداني، وفي مختلف الظروف، رغم ما كان عليه من حالةٍ ملازمةٍ من الضَّعف والمرض. فكان الجميع يعوّلون عليه- علميًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا- فما عرفتُ أحداً من الأقارب إلا كان يعتمد على الأستاذ سلمان في شأن من شؤون الحياة، في حين لم أعرف عنه يومًا اعتماده على أحدٍ من الناس:
وإنما رَجُلُ الدُّنيا وواحدُهـا
مَنْ لا يُعوِّلُ في الدُّنيا على رَجُلِ
حتى لقد عاش- بحكم الظروف- متفرّداً في الحياة، لا صاحبة ولا ولدًا. فصدق فيه- رحمه الله- ما عبّر عنه شقيقه (الأستاذ يحيى بن محمّد الفَيْفي) في وصفه: "كان يحبّ الغربة، عاش مغترباً، ومات مغترباً".
- 2 -
ولئن لم نكن هاهنا بصدد تقديم دراسة فنّيّة عن شعره، إلا أنه لا مناص من بعض ملحوظات، في ضوء ما ذيّلنا به القصائد من شروح وتعليقات متفرّقة.
فلقد بدا الشاعر من حيث اللغة والأسلوب يراوح بين الجزالة- إلى حدّ الإغراب في بعض الحالات- وميلٍ في بعض نصوصه إلى سهولة الأسلوب، حد الاقتراب من اللهجة الدارجة، كاستعماله صيغة "عيوني"، مثلاً، بدل "عينيّ"، أو "متون"، بدل "متنين".. ونحو هذه من الاستعمالات التي تجاري محكيَّ اللغة. هذا فضلاً عن استعمالاتٍ عاميّة خالصة في بعض النصوص، يحاكي بها لغة الناس اليوميّة، كما في قصيدة "رنين وأنين"، (ص269)، مثلاً. وجميع الشروح على هذا- أو التعليقات على غيره- هي من محقّق الديوان، سوى النـزر اليسير، الذي نَبَّهْنا فيه إلى أنه من وضع الشاعر نفسه. إلا أننا لم نعمد إلى شرح الغريب، إنْ وُجِد، إلاّ حيثما ظهر فيه إشكال دلاليّ، ولاسيما إن ارتبط باللهجة المحلّية، أو جاء يحمل إشارة تستدعي الإيضاح. وما عدا ذلك لم نَرَ الشَّرْحَ إلاّ قيدًا على النصّ، الأَولى تركُ شأنه لتعدّد القراءات، بمستوياتها المتنوّعة.
وفي مجال الموسيقى الشعريّة، يُلحظ ثراء الإيقاعات لدى الشاعر. فلقد استخدم معظم البحور الشعرية، ونَظَمَ على شتى القوافي، وزاوج بينها ونوّع. وكان بذوقه يُلبِس الوزن القديم خفّة تُذهب عنه غُلواء الجَرْس، حتى إنه في استخدامه البحر المديد مثلاً- وهو من بحور استثقلها القدماء وتخفّفوا منها- يستعمل منه محذوف العَروض والضرب مخبونهما، في قصيدة "لوحة من بلدي"، (ص72)، فيأتي وزنه في غاية العذوبة والانسياب.
غير أنها قد لوحظت بعض ظواهر اختلال في الوزن في بعض النصوص، يمكن القول إنه يكمن وراءها أحد السببين الآتيين، أو كلاهما:
1) بعض الزحافات هي أصلاً نتيجة تحوّل المنطوق إلى مكتوب؛ إذ إن الشاعر يتّكئ على طريقة الإلقاء، التي قد تُشبَع فيها حركة، أو يُمَدّ فيها صوت، فينجبر الكسر، أو ينتفي الثِّقَل، وهو ما لا يُتاح تمييزُه لقارئ النصّ، كما يُتاح له لو تلقّاه سماعًا. ولعل هذه الظاهرة تُلحظ شائعةً لدى جيلٍ مضَى، يَغلب عليه إرث الثقافة الشفاهيّة، تلقَّى الشعر سماعًا، قبل أن يقرأه، ونَظَمَهُ صوتيًّا، قبل أن ينظمهُ مكتوبًا. وتلك إشكاليّة بين المنطوق والمكتوب قديمة، قِدَم الشعر العربي.
2) في بعض الحالات تَصْدُقُ على الشاعر المقولة المنسوبة لأبي العتاهية، حينما أخذ عليه العروضيّون خروجه عن قواعد العَروض، فقال: "أنا أكبر من العَروض!". وذلك كاستخدام شاعرنا (الخبن) في البحر السريع، في قصيدة "بيروت"، (ص277). إذ إن الخبن- بحسب العَروضيين- يكثُر ويحسُن في تفعيلة "مستفعلن"، في بحر الرَّجَز، في حين أن (الطيّ) يكثر ويحسُن في التفعيلة نفسها من البحر السريع. لكن الشاعر استخدم (الخبن) في السريع كذلك. بل جمع بينه والطيّ في تفعيلة واحدة، وهو ما كان العَروضيون يستثقلونه حتى في الرَّجَز.
على أنه ينبغي عدم إغفال عامل آخر وراء بعض ما قيل حول المستوى اللغوي أو الموسيقيّ لدى الشاعر. وهو أن الرّجل- فيما يبدو- كان يعوّل أحيانًا على السليقة، دون إعادة النظر في القصيدة. بل ربما كانت بعض النصوص بمثابة تجارب أولى لم ينقّحها الشاعر. فنحن هنا- إذْ نتصدّى لنشر ما لم يُبادر الشاعر نفسه إلى نشره- إنما نتعامل مع مخطوطات، لعل بعضها لم يصل إلى درجة الرضى الفنيّ التامّ من قِبَل الشاعر.
أمّا إذا تجاوزنا جانب العَروض من البناء الموسيقي، فسنقف على وعي الشاعر بما للغة الشعريّة من صنعةٍ خاصّة، وذلك من خلال احتفائه، غير المتكلّف، بموسيقى الشعر الداخليّة. وظاهرة الموسيقى الداخلية لديه كانت تُضفي على شعره غنائيّة عذبة، حتى في قصائد المناسبات، كقصيدة "في رحاب الشمال"، (ص42)، على سبيل المثال. كما يمكن الإشارة إلى مثال آخر واضح أيضًا في توظيف صوت (الفاء) في آخر نصّ "مواقف متوهجة"، (ص172)، وما أدّاه هناك من وظيفة إيحائية في تصوير التغيّر والتصوّح، الذي جاء النص معبّرًا عنه.
وعلى صعيد الصورة الشعريّة ظلّ الشاعر أقرب إلى المحافظة على التقاليد الفنّيّة، ضمن "كلاسيكيّتها" الحديثة. حتى إنه في غَزَله قد يميل إلى وصف التجربة الواقعيّة بشكلٍ مباشر. بل لقد عَبَّر في بعض نصوصه الشعريّة- كما ورد في مقابلةٍ معه (النموذج المخطوط رقم 9)- عن موقفه النقديّ والثقافيّ الحادّ من التحديث في الشعر، حسب التيارات المعاصرة. ولذلك لم يكن مُسْتَغْرَبًا أنْ لم يكتب قصيدةً تفعيليَّة قط. فقد بقي أمينًا لبيئته المعرفيّة الأُولَى وانتمائه التراثي الخالص.
- 3 -
وعلى الرغم من حرصنا على إثبات نصوص الشاعر كاملة، فقد كنّا أمام بعض النصوص التي استدعتْ التوقّف. منها:
أولاً، مخطوطات لمطالع أو لقصائد لم يستكملها الشاعر، وما زالت تحمل تشوّش البدايات. فاستُبعدت؛ إذ ما نظنّ الشاعر كان ليرضى عن نشرها بصورتها تلك. أمّا ما رأيناهُ جديرًا بالإثبات، كقصيدته بعنوان "الشاعر"، (ص79)- ولعلّها آخر ما كتبه- فقد اجتهدنا في صياغته وترتيب أبياته، منوّهين عن تفاصيل ذلك في مواطنه من الديوان.
ثانيًا، مخطوطات أُخرى بدا من الواضح أن الشاعر ما كَتَبَها ليُذيعها في الناس، وإنما كَتَبَها على سبيل التفكّه في لحظات عابرة، أو لمعابثات شخصية، فهي رهينة المواقف الخاصّة جدًّا من حياة الشاعر. فعددناها من جملة أوراقه الخاصّة، التي لم نر من حقّنا إعلانها ونشرها. على أن من نصوص هاتين الفئتين (أوّلاً وثانيًا) ما أُدرج ضمن صور مخطوطاته، اللاحقة نماذجها بعد هذه المقدمة.
ثالثًا، ما يدخل من النصُّوص في باب الإخوانيات، وطابع الارتجال فيه غالب على التجويد الفنّي. فأُخذ منه ما قُدّر أن الشاعر كان سيَقبل نشره.
رابعًا، وجدنا من نَظْمه للمناسبات ما صاغه على ألسنة تلاميذ المدارس، وذلك للإلقاء، أو الإنشاد في أثناء حفل مدرسي، أو استقبال ضيف ما. فأُثبت منه ما بدا صالحًا للنشر، دون غيره.
ما عدا تلك الاستثناءات- وهي لا تعدو بضعة نصوص قليلة العدد والأهمية- جُعل جميعًا بين يدي القارئ، بوصفه مادة توثيقية شاملة لتجربة الشاعر، في تنوّعها، واختلاف درجاتها.
- 4 -
ولمّا وقفتُ على المادّة بعد جمعها، ألفيْتُ بين يديّ من القصائد ما يتطلّب التصحيح والضبط. فأجريتُ عليه ذلك. ومنها كثيرٌ ما زال مخطوطًا بالقلم، أو بالآلة الناسخة، فقُمتُ على طباعته، باذلاً الجُهد في ضبطهِ، وتخريج ما قد يكون من اختلاف النصوص بين المخطوطات، حسبما هو مثبتٌ في حواشي القصائد. فلقد كُنتُ أتوخّى الدّقّة والأمانة في إثبات ما كتبَهُ الشاعر، دون التدخّل بتعديل أو تحوير، إلاّ في أضيق الحدود، وحينما تدعو الضرورة الفنّيّة إلى ذلك، مع الإشارة إلى ما في الأصول. ذلك لأنني وجدتُ من القصائد ما مرّ بين يدي الشاعر بأطوار مختلفة، هي في حقيقتها أطوار من حياته نفسها، ولعل أبرز النماذج التي تُمثّل ذلك قصيدة "جدبٌ وسراب"، (ص236). فأثبتُّ في المتن صيغة الشاعر التي بَدَت لي الأخيرة- إذ لم يكن الشاعر عمومًا يُعنى بإثبات تواريخ النصوص- ثم ذكرتُ الاختلافات، أو الزيادات، في حواشي الصفحات. بل لقد تبدّى خلال هذا أن الشاعر كان يستلّ بعض النصوص من قصائد قديمة، لتُوافق مناسبات لاحقة؛ فلم يكن من الأمانة الفنّيّة ولا النقديّة إهمال المادّة الشعريّة في صورتها الكاملة، ولاسيما حينما يبدو الاختلاف بين النُّسَخ كبيرًا وجديرًا بالتنويه، كما في النصّ المشار إليه.
ولقد كان في سابق علاقتي، شبه الملازمة للشاعر، ما أفادني في عملي على بعض نصوصه. ففضلاً عن صلة القرابة، وقضائي قِسْطًا من صباي في كنفه، كنتُ قد صحبته سنوات في الرياض، كما رافقته في حِلّه وسفره داخل المملكة وخارجها. فسمعتُ منه كثيرًا، وشاركته القراءات كثيرًا، وكانت بيني وبينه من شؤون الثقافة ما يتعدى شؤون القرابة، حتى لأزعم أنني من أكثر الناس معرفةً به. وهذا ما هيّأ لي إدراكًا للظروف التي أحاطت ببعض النصوص، وإلمامًا بالسياقات التي قيلت فيها. كما أتاح لي معرفة الزمان والمكان اللذين قيلت فيهما بعض القصائد، وما قد يكون لحقها بعدئذٍ من تغييرٍ أو تطوير.
- 5 -
وقد جاءت الأغراض الشعريّة التي نظم الشاعر فيها من التنوع بحيث شملت: السياسيّ، والوطني، والعاطفيّ، والاجتماعي، إلى غيرها من المجالات. ولا غرو، فهذا نتاج قرابة أربعين سنة من الشعر. مع أني لا أشكّ في أن الشاعر قد ضيّع من نتاجه ما يعادل ما أَبْقَى، وربما أكثر؛ إذ لم يكن مهتمًّا بجمع شعره في ديوان. وبالرغم من هذا الحضور الموضوعي وراء نصوص الشاعر، فقد آثرنا في ترتيب القصائد منهاج الترتيب الهجائيّ- بحسب القوافي- على التصنيف بحسب الموضوعات أو الأغراض؛ كي يسهل وصول القارئ إلى النصّ في مكانه من الديوان. أمّا القصائد متنوعة القوافي، فأُدرجتْ في مكانها وفقًا لقافية المقطع الأول منها. واتُّبِع في ترتيب القصائد من قافية واحدة المنهاج المتعارف عليه لدى المحققين، بدءًا بالقوافي المقيدة، فالمنصوبة، فالمضمومة فالمكسورة. ثم تُرتّب القصائد ضمن كل حرف مقيّد أو متحرّك بالنظر إلى ترتيب البحور الشعرية في علم العَروض، بدءًا بالبحر الطويل، فالمديد، فالبسيط.. وهلم جرًّا.
* * *
وقبل أن نُقدّم إلى القارئ مادة هذا الديوان، بدا من المفيد، والدالّ معًا، أن نأخذه في رحلة مع سجلّ الشاعر من المخطوطات الشعريّة. وليس الغرض من ذلك هاهنا إظهار الأصول المخطوطة التي انطلق منها العمل المنشور- كما هو العُرف العلمي- فحسب، ولكن أيضًا أن تكون تلك الصور بمثابة معرضٍ فنّيّ لقلم الشاعر الأنيق، وهو يعايش آلامه وآماله وكلماته، عبر أطوار مختلفة، وتفاعلات متعدّدة مع المحيط الشخصيّ والعام.
* * *
وبعد، فإن هذا العمل لم يكن له أن يرى النور لولا الاهتمام البالغ من قِبَل شقيق الشاعر، خالي الأستاذ يحيى بن محمّد الفَيْفي، الذي حافظ على تلك النصوص التي تركها الشاعر، حتى دفع بها إليّ، للعمل على تحقيقها وإعدادها للنشر. كما كان في حثّه ومتابعته، وحرصه على خروج العمل بالصورة اللائقة، الدافع الأول للشروع في العمل والاستمرار فيه. وكان بعض أولاده- بنات وبنين- قد بادروا إلى نَسْخ كثير من القصائد، بهدف التداول الشخصي، فكان ذلك الجهدُ لَبِنَةً في إنجاز هذا العمل على صورته الحاليّة. فلأولئك جميعًا جزيل الشكر وخالص الدعاء.
والله نسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشاعر، وأن لا يحرمنا- وكلَّ من أسهم فيه- الأجر، كِفاء ما ابتغيناه وراء إخراجه من خدمة اللغة، وحِفْظِ مأثورات التراث والأدب.
د. عبدالله بن أحمد الفـَـيفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الخَشْعَة: البقعة المركزية من جبل آل أبي الحكم في فَيْفاء، حيث كان منزل الشاعر والمدرسة التي تلقّى تعليمه الأوليّ فيها.
2 فَيْفاء: منطقة جبلية، في جنوب المملكة العربية السعودية، شرقي مدينة جازان. تقطنها قبائل تعود في نَسَبها إلى خَولان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة.
3 معهد الخَشْعَة: أسّسه الوالد الشيخ أحمد بن علي بن سالم الفَيْفي، في جبل آل أبي الحَكَم، سنة 1373/ 1374هـ. وكان مَدْرَسَة للبنين والبنات، استمرّ عمله إلى آخر سنة 1377هـ، وخرّج عددًا من المتعلّمين والمتعلّمات في فَيْفاء. وكان من مدارس المنطقة التي حظيت برعاية الشيخ عبد الله القرعاوي.
4 الشيخ عبد الله بن محمّد بن حَمَد القرعاوي: مُصْلِح دينيّ، يُنسب إلى قرية القرعا شماليّ بريدة بالقصيم، وُلد سنة (1315هـ= 1898م). قَصَد تهامة 1358هـ، فأنشأ المدارس في سامطة وما جاورها، وأعان على إنشائها، وامتدّت مدارسه إلى عسير. توفي بالرياض سنة 1389هـ= 1969م. (يُنظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، (بيروت: دار العلم للملايين، 1984)، 4: 135).
5 عَرْعَر: مدينة على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية مع العراق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوافر حاليًّا في: مكتبة الرُّشْد، الرياض؛ مكتبة العبيكان، الرياض. بالإضافة إلى نادي جازان الأدبي.
كذلك يمكن تحميل نسخة خاصة من الديوان من هنا
 (7.92
Mb)
(7.92
Mb)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكراً لاطّلاعك على هذا الكتاب!
